الدكتور محمد سيد أحمد: الهندسة الانتخابية في مصر !!


لم يعد المشهد الانتخابي في مصر، سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ساحة تنافس سياسي حقيقي كما كان يؤمل عقب أحداث يناير ٢٠١١ ، ويونيو٢٠١٣، بل تحول إلى ما يشبه إجراءً شكليًا يعاد فيه إنتاج النخبة نفسها، بأسماء جديدة أحيانًا، ولكن بالآليات القديمة ذاتها: المال السياسي، والتوجيه الأمني، والإقصاء المجتمعي، وغياب الشارع تمامًا عن الفعل السياسي.
تاريخيًا، كانت الانتخابات في مصر، رغم ما شابها من تدخلات، مناسبة لإظهار الحد الأدنى من التنافس بين التيارات والقوى المختلفة أما اليوم، فقد أفرغت العملية الانتخابية من مضمونها السياسي بالكامل، فالأحزاب أصبحت صورية، تتجمع في قوائم معدة سلفًا، يغيب عنها أي طابع برامجي أو رؤى متباينة، وبدل أن تكون الانتخابات وسيلة لتجديد النخب السياسية وإعادة ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، صارت وسيلة لإعادة توزيع الولاءات وترتيب المقاعد بما يخدم التوازن الذي تراه السلطة مناسبًا، فمجلس الشيوخ، الذي أعيد تأسيسه عام 2020 بوصفه "غرفة للعصف الفكري"، تحول إلى منبر شكلي للمباركة والمصادقة على قرارات السلطة التنفيذية، دون أن يلعب دورًا رقابيًا أو استشاريًا حقيقيًا، أما مجلس النواب، فرغم أنه منوط بالتشريع والرقابة، فإنه بات نسخة إجرائية من الجهاز التنفيذي، تندر فيه المعارضة الفعلية، وتتراجع فيه ممارسات النقد والمساءلة، لصالح خطاب واحد متجانس يعكس رؤية الدولة لا المجتمع.
يتحدث المصريون في القرى والمراكز والمدن عن انتخابات "الشنط" و"الكوبونات" و"الرشاوى المقنعة"، حتى أصبح المال السياسي هو اللغة الوحيدة المفهومة في موسم الانتخابات، فالمقعد النيابي لم يعد ينتزع بالكفاءة أو البرنامج أو القاعدة الشعبية، بل بالقدرة على الإنفاق، والاتصال بالعلاقات النافذة، وأصبح المال وسيلة مزدوجة: فهو من جهة يمول العملية الانتخابية المكلفة والمنهكة التي تفتقر إلى دعم حزبي حقيقي، ومن جهة أخرى يستخدم لشراء الولاء أو استرضاء المتحكمين في مسار الترشيحات، هذه الديناميكية أفرزت مشهدًا غريبًا: من يملك المال لا يحتاج إلى برنامج، ومن يملك النفوذ لا يحتاج إلى جمهور، وهكذا تراجع الوعي الانتخابي أمام ثقافة "المصلحة"، وتحول المقعد البرلماني إلى استثمار اقتصادي أكثر منه تمثيلًا سياسيًا.
فمنذ سنوات، أصبح الحديث عن "الهندسة الانتخابية" مصطلحًا دارجًا في الوسط السياسي المصري، فكل ما يجري في الكواليس — من إعداد القوائم إلى توزيع المقاعد، ومن فحص المرشحين إلى مراقبة الحملات — يتم بإشراف غير مباشر من الأجهزة السيادية التي ترى في الانتخابات وسيلة للضبط، لا للتعبير عن الإرادة الشعبية، وتبدو القوائم الموحدة للأحزاب الموالية — التي تحمل أسماء مثل "القائمة الوطنية من أجل مصر" — مثالًا واضحًا على ذلك، إذ تضم وجوهًا من اتجاهات مختلفة، لكنها تشترك في القاسم الأعظم وهو الرضا الرسمي، والنتيجة أن البرلمان تحول إلى غرفة تناغم واحدة، تدار بالتوجيه، لا بالجدل السياسي أو التعددية.
في كل دورة انتخابية جديدة، تزداد نسبة العزوف الشعبي، حتى أصبحت الانتخابات تمر في هدوء صامت يشي أكثر مما يخفي، فالناخب المصري، الذي كان يقف بالساعات في طوابير طويلة في أعقاب ٢٥ يناير ٢٠١١، لم يعد يشعر بأي معنى للمشاركة، والأسباب متعددة: أولها الإحباط من التجارب السابقة، وثانيها انعدام الثقة في نزاهة النتائج، وثالثها الشعور بعدم جدوى الصوت الفردي في ظل نتائج محسومة مسبقًا، وهذا الغياب ليس مجرد "لامبالاة"، بل هو موقف احتجاجي صامت، يعبر عن انسحاب المجتمع من معادلة لا يرى نفسه فيها، فحين يشعر المواطن أن صوته لا قيمة له، وأن النتائج معروفة مسبقًا، فإن الصمت يصبح فعلًا سياسيًا مضادًا، ورسالة ضمنية بأن المشهد فقد صدقيته.
في المجتمعات الديمقراطية، تقاس شرعية النظام السياسي بمستوى المشاركة الشعبية، وبالقدرة على تداول السلطة والتعبير عن التنوع الاجتماعي والسياسي، لكن في الحالة المصرية، أصبح البرلمان مؤسسة بلا قاعدة اجتماعية حقيقية، إذ لا يمثل إلا دوائر ضيقة من رجال الأعمال والبيروقراطيين والمحسوبين على السلطة، وهذا الغياب للتنوع أنتج فقرًا تشريعيًا ورقابيًا واضحًا، وجعل البرلمان أقرب إلى منصة للتصفيق منه إلى مجلس تشريعي فاعل، بل إن القوانين التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة — سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية — تمت بسرعة وبدون نقاش مجتمعي، ما يعكس هشاشة المشاركة وتمركز القرار في أضيق نطاق.
حين يغيب التنافس الحقيقي، يصبح التزييف جزءًا من المنظومة لا من الاستثناء، فالتزوير لم يعد بالضرورة في "الصندوق"، بل في البيئة المحيطة بالانتخابات كلها: في من يسمح له بالترشح، ومن يقصى، ومن يحصل على تغطية إعلامية، ومن يتم تهميشه، حيث تتم صناعة النتيجة قبل بدء التصويت، عبر سلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية والإعلامية التي تضمن الشكل الديمقراطي دون المضمون، فالصندوق قد يكون نظيفًا، لكن اللعبة برمتها مبرمجة مسبقًا بحيث لا تنتج إلا ما هو متوقع.
يتفاعل المواطن المصري مع المشهد الانتخابي اليوم بنوع من الاغتراب السياسي، فهو يدرك أن المشاركة لن تغير شيئًا، وأن المعارضة قد تفسر كتمرد، وأن المرشح المستقل أو الجريء لن يجد مساحة للتحرك، هذا الإدراك يولد إحباطًا عامًا وشعورًا بعدم الجدوى، لكنه أيضًا يعمق الخوف من التعبير، إذ ارتبط العمل السياسي في الوعي الجمعي بالمخاطرة لا بالواجب الوطني، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وانشغال المواطنين بلقمة العيش، أصبح الاهتمام بالانتخابات ترفًا غير ذي أولوية، يضاف إلى قائمة القضايا التي لا يملك الشارع التأثير فيها.
المشهد الراهن لا يعني موت السياسة تمامًا، بل يشير إلى انتقالها من المجال العام إلى الفضاءات المغلقة، في المقاهي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمجموعات الصغيرة التي تتداول الرأي بعيدًا عن الأطر الرسمية، لكن هذه السياسة الهامشية تظل بلا وزن مؤسسي، وبلا أفق تنظيمي، ما يجعلها عرضة للاحتواء أو التشظي، فإذا أرادت مصر مستقبلًا مختلفًا، فإن إحياء السياسة يبدأ بإعادة الاعتبار للانتخابات كآلية حقيقية للاختيار لا للتزيين، ويتطلب ذلك تحرير المجال العام من القيود، وتشجيع الأحزاب المستقلة، وضمان العدالة في التنافس، وإعادة الثقة للناخب بأن صوته يحدث فرقًا، فالدولة التي تسيطر على كل شيء تفقد تدريجيًا قدرتها على تجديد شرعيتها، لأن الشرعية لا تصنع في المكاتب، بل تولد من المشاركة الحرة للناس.
يبدو أن مصر تعيش اليوم أزمة تمثيل لا أزمة انتخابات، فالصناديق تفتح وتغلق في مواعيدها، لكن الناخبين يغيبون، والمرشحين يختارون، والنتائج تعلن دون مفاجآت، وفي ظل استمرار هذا المسار، ستتعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وسيفقد البرلمان معناه بوصفه صوت الشعب، فالمشهد الحالي ليس دلالة استقرار كما يروج، بل علامة ركود سياسي واجتماعي خطير، يضعف مؤسسات الدولة ويفرغها من مضمونها الديمقراطي، إن ما تحتاجه مصر اليوم ليس انتخابات جديدة بقدر ما تحتاج إلى "عقد اجتماعي جديد" يعيد الاعتبار للمواطن، ويمنح السياسة معناها الأصلي: أن تكون ساحة للاختيار، لا للامتثال، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

.jpg)


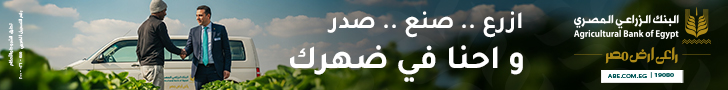






.jpg)
























