الدكتور محمد سيد أحمد يكتب: أربع سنوات .. يوميات ميت بين الأحياء !!


في يوم السابع والعشرين من سبتمبر قبل أربع سنوات توقّف الزمن عندي، فقدت أخي أحمد، الذي لم يكن مجرد شقيق يكبرني بعامين، بل كان رفيق العمر، وصديق الطريق، ومرآة الروح، رحيله لم يكن مجرد حدث عابر في دفتر الحياة، بل كان النهاية الحقيقية لي، وإن بقي الجسد حيًّا يتحرك بين الناس، منذ تلك اللحظة وأنا أعيش يوميات ميت بين الأحياء، جسد يقوم بواجباته، وروح فارقتها الحياة ولم يعد يربطها بالدنيا سوى انتظار الموت الأكبر.
خلال هذه السنوات الأربع، وعلى الرغم من ثِقل الفقد ومرارة الغياب، لم أتخلَّ عن رسالتي الأكاديمية، فأنا أؤمن أن العلم أمانة، وأن دوري تجاه طلابي وباحثيّ لا بد أن يُؤدى كما يجب، كنت أُحاضر وأكتب وأناقش وأصحح، أبدو أمامهم كما كنت دائمًا، الأستاذ الجادّ الملتزم، لكن في داخلي كنت أعيش صراعًا مريرًا بين أداء الواجب كعادة يومية، وبين شعورٍ دفين أنني فقدت شغفي بالحياة، وأن كل إنجاز مهما كان براقًا لا يعوّض غياب أحمد ولا يخفف وجعي عليه.
وفي الميدان السياسي والإعلامي ظللت أمارس دوري بكل حماسة، وقفت ولا أزال في مواجهة مشاريع التفتيت والتقسيم التي تستهدف أمتنا العربية، وفضحت مخططات "الشرق الأوسط الكبير" و"الشرق الأوسط الجديد"، كما كشفت زيف الحلم الصهيوني القديم المتجدد بإقامة "إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات". دافعت عن فلسطين ولبنان وسورية والعراق وليبيا واليمن والسودان، وأدركت أن معركتنا مع الاستعمار وأدواته معركة وجود وليست مجرد خلاف سياسي، كنت أنغمس في هذه القضايا بكل قوة، لكنني في داخلي أعلم أنني أقاتل بروحٍ منكسرة، بروحٍ فقدت سندها الذي كان يربطني بالحياة.
أما على المستوى الإنساني، فقد حاولت أن أكون حاضرًا كما كنت دائمًا، أمي التي تحمّلت فواجع العمر كلها، وجدت نفسها أمام أصعب اختبار حين فقدت أحمد، وأصبحت بحاجة إلى من يساندها ويخفف عنها، وأصبحت أنا أملها الوحيد الذي تعيش من أجله تدعو لي ليل نهار ومع كل صلاة كما تدعو لأحمد بالرحمة والمغفرة، أخواتي البنات حملن الجرح ذاته، وكل واحدة منهن تعيش حنينها الخاص لأخيها الغائب الذي اختفى في غمضة عين، ودون سابق إنذار، كنت أحاول أن أكون لهنّ الأخ والسند والرفيق، لكنني في الحقيقة كنت أستمد منهن ما يساعدني على الاستمرار.
وفي بيتي الصغير حاولت أن أكون الزوج والأب لكن دون جدوى فالجميع أصبح على مسافة بعيدة مني، هم لا يستوعبون ما حدث لي ويعتقدون فقط في تقصيري في حقهم، وأنا أحاول القيام بالحد الأدنى من وجباتي بصبر وصمت، وأمنح أبنائي ما يستطيع أن يمنحهم شعورًا بأن أباهم بخير، لكنني في أعماقي أعرف أنني لم أعد كما كنت قبل رحيل أحمد، وأن أبنائي يعيشون مع أبٍ نصفه غائب، وروحه معلّقة في مكان آخر.
حتى في علاقاتي مع الأصدقاء والزملاء، كنت حريصًا أن أظل وفيًّا للحب والود، حاضرًا بالكلمة والموقف، لكن كل لقاء كان يعيدني إلى ذات الإحساس، أنني أعيش بينهم بجسد ميت، أبتسم حين ينبغي أن أبتسم، وأتحدث حين يتطلب الموقف كلامًا، لكن قلبي هناك، حيث يرقد أحمد تحت التراب.
أربع سنوات كاملة عشتها وأنا أمارس طقوس الحياة بآلية الميت، أفتح عينيّ كل صباح فأجد نفسي أمام نفس السؤال: لماذا أنا هنا؟ ما الذي يبقيني حيًّا بينما الجزء الأجمل والأصدق مني قد رحل؟ أحاول أن أجد معنى في الواجب، في الرسالة، في الدفاع عن الأمة، في خدمة الأسرة، لكن الحقيقة التي لا أستطيع الهروب منها أنني فقدت آخر أجزائي الحية، وبقيت مجرد صدى لإنسان كان ذات يوم ممتلئًا بالحياة.
إنني أكتب هذه الكلمات لا لأشكو، بل لأشهد على تجربة إنسانية صعبة يعيشها كثيرون دون أن يبوحوا بها، فالموت لا يقتصر على اللحظة التي يتوقف فيها القلب، الموت الحقيقي يبدأ مع الفقد، مع رحيل من كانوا حياتنا، عندها نتحول إلى أحياء على هامش الحياة، ننتظر النهاية بصبرٍ ثقيل، ونتعلق بخيط رفيع من الأمل في لقاءٍ آخر حيث لا فراق ولا غياب.
رحمك الله يا أحمد، وأسكنك فسيح جناته، وجمعني بك في مستقر رحمته، لقد كنت شقيقي وصديقي وأبي وابني في آن واحد، كنت الجزء الأصدق في حياتي، وبرحيلك متُّ رغم أنني ما زلت بين الأحياء، واليوم بعد أربع سنوات، أواصل يومياتي كميتٍ بين الأحياء، والكارثة الحقيقية أن كل من حولي لا يعلم حقيقة مشاعري، والجميع يضغط بقسوة ويحملونني فوق طاقتي، أما أنا فأنتظر فقط اللحظة التي تكتمل فيها الحكاية، ويُغلق آخر فصل من كتاب العمر، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

.jpg)


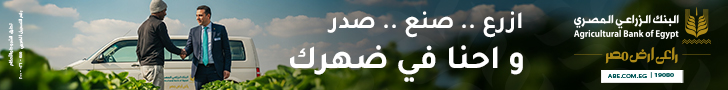






.jpg)
























